في موقع منى الإخباري، نواكب التطورات التقنية ونسلط الضوء على القضايا التي تمس حاضرنا ومستقبلنا الرقمي.
ومع توسع الاعتماد على التكنولوجيا في كل تفاصيل الحياة، أصبحت مهددات أمن المعلومات قضية محورية تمس الأفراد، والمؤسسات، وحتى الدول.
فالمعلومة اليوم لم تعد مجرد بيانات، بل أصبحت ثروة رقمية، وحمايتها ضرورة وجودية لا تقل أهمية عن حماية الحدود الجغرافية.
ما المقصود بمهددات أمن المعلومات؟
يقصد بـ مهددات أمن المعلومات كل ما يمكن أن يؤثر سلبًا على سرية البيانات وسلامتها وتوافرها.
وتتنوع هذه المهددات بين عوامل بشرية وتقنية وطبيعية، وقد تكون مقصودة أو غير مقصودة.
وتكمن خطورتها في قدرتها على اختراق الأنظمة، تسريب المعلومات، تعطيل الخدمات، أو تدمير الثقة الرقمية التي تقوم عليها المؤسسات الحديثة.
أولًا: المهددات البشرية — الإنسان هو الحلقة الأضعف
رغم التطور الهائل في تقنيات الحماية الرقمية والأنظمة الذكية، يبقى العامل البشري هو التحدي الأكبر والأكثر خطورة في منظومة أمن المعلومات.
فالتاريخ الرقمي يُظهر أن معظم حوادث الاختراق الكبرى لم تكن نتيجة ثغرة تقنية فقط، بل بسبب خطأ بشري بسيط فتح الباب أمام المهاجمين.
وقد أكدت تقارير الأمن السيبراني العالمية أن ما بين 70 إلى 90٪ من الهجمات الإلكترونية تبدأ بسبب تصرف أو قرار خاطئ من أحد الموظفين داخل المؤسسة، حتى دون نية سيئة.
وفيما يلي أبرز أشكال المهددات البشرية التي تواجه المؤسسات يوميًا:
الإهمال أو الخطأ البشري
هو أكثر المهددات شيوعًا، وغالبًا ما يحدث نتيجة قلة الانتباه أو ضعف الوعي بالأمان الرقمي.
فقد يفتح الموظف رابطًا في رسالة بريد إلكتروني مجهولة، أو يقوم بتحميل ملف مرفق يحتوي على برمجية خبيثة دون أن يدرك ذلك.
وفي لحظة واحدة، يمكن لمثل هذا الخطأ أن يمنح المخترقين منفذًا مباشرًا إلى شبكة المؤسسة أو بياناتها الحساسة.
كما يشمل الخطأ البشري حالات مثل:
- ترك الأجهزة مفتوحة دون تسجيل خروج.
- مشاركة كلمات المرور مع الزملاء.
- استخدام شبكات “Wi-Fi” عامة في أثناء الوصول إلى أنظمة العمل.
وتُظهر الدراسات أن الاختراق لا يحتاج دائمًا إلى تقنية معقدة، بل أحيانًا إلى موظف واحد يتصرف بعفوية.
🧠 الهندسة الاجتماعية (Social Engineering)
تُعد الهندسة الاجتماعية من أخطر الأساليب الحديثة في الاحتيال الإلكتروني لأنها تستهدف العقل البشري قبل النظام التقني.
وهي تعتمد على الخداع النفسي والإقناع، حيث يقوم المهاجم بانتحال صفة جهة موثوقة — مثل البنك، أو مدير في المؤسسة، أو الدعم الفني — لإقناع الضحية بمشاركة بيانات حساسة أو تنفيذ إجراء معين.
أشهر هذه الأساليب تشمل:
- التصيد الإلكتروني (Phishing): عبر رسائل بريدية أو مواقع مزيفة.
- المكالمات الهاتفية الاحتيالية (Vishing): حيث يدّعي المهاجم أنه موظف رسمي ويطلب معلومات سرية.
- خداع موظفي الدعم الفني: للحصول على صلاحيات دخول للنظام.
وتكمن خطورة هذا النوع من الهجمات في أنه يستغل الثقة الإنسانية، وليس الثغرات التقنية. ولذلك، فإن الوقاية منه تتطلب تدريبًا مستمرًا وتعزيز الوعي الأمني لدى كل موظف.
🔒 الموظف الداخلي الخطر (Insider Threat)
لا يأتي الخطر دائمًا من الخارج. ففي بعض الحالات، يكون التهديد من داخل المؤسسة نفسها.
فقد يستغل موظف حالي أو سابق صلاحياته للوصول إلى معلومات حساسة، أو يقوم بتسريبها عمدًا أو عن طريق الإهمال.
وتتنوع دوافع هذا النوع من التهديد بين:
- الرغبة في الانتقام أو الإضرار بالمؤسسة.
- الدافع المالي أو بيع المعلومات.
- ضعف الرقابة على صلاحيات الدخول للأنظمة.
وتشير بعض الدراسات إلى أن 30% من التسريبات الأمنية مصدرها موظفون أو متعاقدون داخليون.
لذا، من الضروري أن تتبنى المؤسسات سياسات صارمة للتحكم في الصلاحيات، وأن تقوم بمراجعة دورية للحسابات المصرح لها بالدخول إلى البيانات الحساسة.

🧩 نقص الوعي الأمني
يُعد غياب الثقافة الأمنية من أخطر المهددات غير التقنية التي تواجه المؤسسات.
فحتى مع وجود أحدث الأنظمة، إذا لم يكن المستخدم مدركًا لأهمية الأمان الرقمي، فإن النظام بأكمله يبقى معرضًا للخطر.
عدم الوعي يشمل ممارسات بسيطة لكنها خطيرة مثل:
- استخدام كلمات مرور ضعيفة أو مكررة.
- تجاهل تحديث البرامج والأنظمة.
- مشاركة معلومات حساسة على شبكات التواصل.
ولذلك أصبحت المؤسسات الرائدة تنفذ برامج توعية دورية تشمل محاكاة لهجمات تصيد واقعية، وتدريبات تفاعلية لرفع وعي الموظفين.
خلاصة القول، تؤكد الجهات الأمنية وخبراء التقنية أن “أقوى أنظمة الحماية يمكن أن تنهار بنقرة واحدة من موظف غير مدرّب”.
ولهذا، فإن الاستثمار في الإنسان لا يقل أهمية عن الاستثمار في التكنولوجيا.
فبناء ثقافة أمن معلومات قوية داخل المؤسسة هو الدرع الحقيقي ضد كل المهددات الرقمية، وهو ما تسعى إليه اليوم كبرى الجهات الحكومية والخاصة في المملكة ضمن مسار التحول الرقمي الآمن لرؤية 2030.
ثانيًا: المهددات التقنية — الخطر المتطور باستمرار
- لفيروسات والبرمجيات الخبيثة (Malware)
تُعد البرمجيات الخبيثة من أقدم وأخطر أدوات الهجوم السيبراني، وهي برامج يتم زرعها عمدًا داخل الأنظمة بهدف تدمير البيانات أو سرقتها أو التجسس على المستخدمين.
وتتنوع هذه البرمجيات بين:
- الفيروسات (Viruses): التي تنتقل بين الملفات والأجهزة وتنتشر بسرعة داخل الشبكات.
- أحصنة طروادة (Trojans): تبدو وكأنها برامج آمنة لكنها تُستخدم لفتح “أبواب خلفية” للمخترقين.
- برمجيات التجسس (Spyware): تراقب أنشطة المستخدم دون علمه وتجمع معلومات حساسة مثل كلمات المرور.
- الديدان (Worms): تنتشر ذاتيًا عبر الشبكات دون الحاجة لتدخل المستخدم.
وتكمن خطورتها في قدرتها على البقاء خفية داخل النظام لفترات طويلة، مما يسمح للمهاجمين بجمع بيانات دقيقة أو استخدام الأجهزة المصابة لتنفيذ هجمات أكبر.
ففي السنوات الأخيرة، شهد العالم هجمات خبيثة مثل WannaCry وNotPetya التي أصابت آلاف الأنظمة في مؤسسات حكومية وخاصة حول العالم.
- برامج الفدية (Ransomware)
تُعد برامج الفدية من أخطر المهددات التقنية الحديثة وأكثرها تأثيرًا على المؤسسات.
تعمل هذه البرمجيات على تشفير ملفات المستخدمين أو الأنظمة بالكامل، ثم تطالب بفدية مالية — غالبًا بالعملات الرقمية — مقابل فك التشفير واستعادة البيانات.
الخطير في هذه الهجمات أنها تعطل الأعمال الحيوية فورًا، وقد أجبرت شركات ومستشفيات وجهات حكومية على التوقف التام عن العمل.
فعلى سبيل المثال، تسبب هجوم فدية على شبكة صحية أوروبية عام 2023 في تعطيل خدمات الرعاية الصحية لآلاف المرضى، مما دفع الحكومات إلى الاستثمار بشكل أوسع في الأمن الوقائي.
وتزداد خطورة هذه الهجمات لأن منفذيها لا يكتفون بالمطالبة بالفدية، بل يهددون أيضًا بنشر البيانات الحساسة على الإنترنت إذا لم يتم الدفع.
- 📧هجمات التصيد الإلكتروني (Phishing)
يُعتبر التصيد الإلكتروني من أكثر المهددات انتشارًا لأنه يستغل ضعف العنصر البشري بدلًا من الثغرات التقنية.
تبدأ العملية برسائل بريد إلكتروني أو روابط مزيفة تبدو وكأنها من جهات موثوقة — مثل البنوك أو المؤسسات الرسمية — وتطلب من المستخدم إدخال بياناته الشخصية أو البنكية.
مع تطور الذكاء الاصطناعي، أصبحت هذه الرسائل أكثر إقناعًا من ذي قبل، حيث يمكنها تخصيص الرسالة باسم الضحية ووظيفته ولغته، مما يجعل اكتشافها أمرًا صعبًا للغاية.
ويُستخدم التصيد اليوم كمرحلة أولى في هجمات أكبر، إذ يُمكن من خلاله الحصول على بيانات تسجيل الدخول لاختراق الشبكات المؤسسية لاحقًا.
وقد حذرت تقارير أمنية من أن أكثر من 80٪ من الاختراقات تبدأ برسالة تصيد واحدة ناجحة، ما يجعل التدريب والوعي الأمني خط الدفاع الأول ضد هذا النوع من الهجمات.
- 🧩ثغرات الأنظمة (Vulnerabilities)
تُعد الثغرات الأمنية في البرامج أو الأنظمة أحد أكثر الأبواب التي يستغلها القراصنة للوصول إلى الشبكات.
هذه الثغرات قد تكون نتيجة أخطاء برمجية أو إعدادات غير صحيحة أو ضعف في التحديثات الأمنية.
وفي كثير من الحالات، يتم استغلالها خلال ما يُعرف بـ "صفر يوم" (Zero-Day)، أي قبل أن يكتشفها المطورون أو يصدروا تحديثًا لإصلاحها.
المؤسسات التي تتأخر في تحديث أنظمتها أو لا تمتلك سياسة صيانة رقمية فعالة تكون الأكثر عرضة لهذا النوع من التهديدات.
ويؤكد الخبراء أن تحديث الأنظمة بشكل دوري وتطبيق التصحيحات الأمنية فور صدورها يُعد من أهم خطوات الوقاية.
- 🌐 الهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS)
تُعتبر هجمات DDoS من أكثر المهددات شيوعًا ضد المواقع الإلكترونية والخدمات الرقمية.
تقوم هذه الهجمات على إغراق خوادم الموقع بطلبات اتصال ضخمة جدًا، مما يؤدي إلى بطء أو توقف الخدمة بالكامل.
وتُستخدم عادة لإيقاف مواقع حكومية أو مؤسسات مالية أو حتى منصات إعلامية عن العمل مؤقتًا.
وفي السنوات الأخيرة، شهد العالم هجمات DDoS ضخمة تجاوزت تيرابايتات من البيانات في الثانية الواحدة، استُخدمت فيها شبكات ضخمة من الأجهزة المصابة تُعرف باسم Botnets.
ومع الانتشار الواسع لإنترنت الأشياء (IoT)، أصبح من السهل استغلال الأجهزة المنزلية الذكية مثل الكاميرات أو الموجّهات في تنفيذ هذه الهجمات دون علم أصحابها.
📊 تصاعد الخطر بالأرقام
تشير تقارير أمنية حديثة إلى أن أكثر من 60% من المؤسسات حول العالم تعرضت لمحاولة اختراق واحدة على الأقل خلال العام الماضي، وأن متوسط تكلفة الهجوم الواحد تجاوز 4 ملايين دولار أمريكي.
هذه الأرقام تعكس أن المهددات التقنية لم تعد مسألة محتملة، بل واقعًا يوميًا يتطلب استعدادًا دائمًا واستثمارًا مستمرًا في الأمن السيبراني.
ثالثًا: المهددات التنظيمية والإدارية
ليست كل الأخطار رقمية بحتة، فبعضها ناتج عن ضعف في إدارة أمن المعلومات داخل المؤسسات.
ومن أبرز هذه المهددات:
- غياب سياسات أمن معلومات واضحة تحدد الصلاحيات والمسؤوليات.
- عدم تحديث الأنظمة والبرامج بشكل دوري.
- ضعف النسخ الاحتياطي أو فقدان خطط الاستجابة للطوارئ.
- إهمال التدقيق الأمني ومتابعة الالتزام بالمعايير الدولية مثل ISO 27001.
المؤسسات التي لا تمتلك هيكلًا إداريًا للأمن السيبراني تكون أكثر عرضة للخسائر حتى لو امتلكت أحدث الأدوات التقنية.
رابعًا: المهددات الطبيعية والبيئية
قد تبدو أقل شيوعًا، لكنها قد تكون مدمرة إذا لم يُستعد لها جيدًا.
ومن أمثلتها:
- الكوارث الطبيعية مثل الحرائق والفيضانات والزلازل التي قد تتلف الخوادم أو مراكز البيانات.
- انقطاع التيار الكهربائي أو الأعطال المادية في الأجهزة.
- الأخطاء في بيئة التخزين السحابي نتيجة خلل تقني أو سوء إعداد.
لهذا تعتمد المؤسسات على مراكز بيانات بديلة وأنظمة نسخ احتياطي جغرافية لضمان استمرارية العمل في حال وقوع الكوارث.
🧠 كيف نواجه هذه المهددات؟
الحل لا يكمن في أداة واحدة، بل في منظومة متكاملة تشمل:
- تطوير استراتيجيات أمن معلومات واضحة تتماشى مع طبيعة المؤسسة.
- التوعية والتدريب المستمر لجميع الموظفين.
- تطبيق تقنيات حديثة مثل التشفير والمصادقة متعددة العوامل.
- مراقبة الأنشطة الرقمية وتحليلها بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن التهديدات.
- إجراء اختبارات اختراق دورية لتقييم نقاط الضعف.
- إعداد خطط استجابة فعالة للحوادث الطارئة لضمان استعادة الأنظمة بسرعة.
السعودية نموذج رائد في الأمن السيبراني
تحتل المملكة العربية السعودية مكانة متقدمة عالميًا في مجال الأمن السيبراني بفضل جهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، التي وضعت أطرًا ومعايير صارمة لحماية الفضاء الرقمي الوطني.
كما أطلقت مبادرات مثل:
- الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.
- مركز الاستجابة للطوارئ الرقمية (CERT).
- برامج تأهيل الكوادر الوطنية.
هذه الجهود جعلت من المملكة نموذجًا يُحتذى به في بناء بيئة رقمية آمنة ومتطورة تدعم التحول الرقمي الشامل لرؤية 2030.
في الختام، إن مهددات أمن المعلومات ليست مجرد مشكلات تقنية، بل تحدٍ وطني ومجتمعي يتطلب وعيًا وتعاونًا بين الأفراد والمؤسسات.ففي عالمٍ أصبحت فيه البيانات الثروة الجديدة، فإن حمايتها تمثل الخط الدفاعي الأول عن الاقتصاد، والأمن، والسيادة الرقمية.








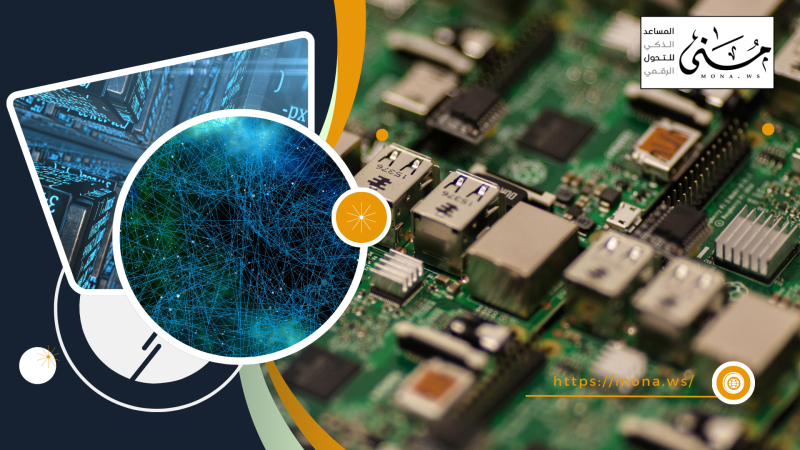

التعليقات
إضافة تعليق جديد